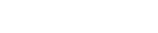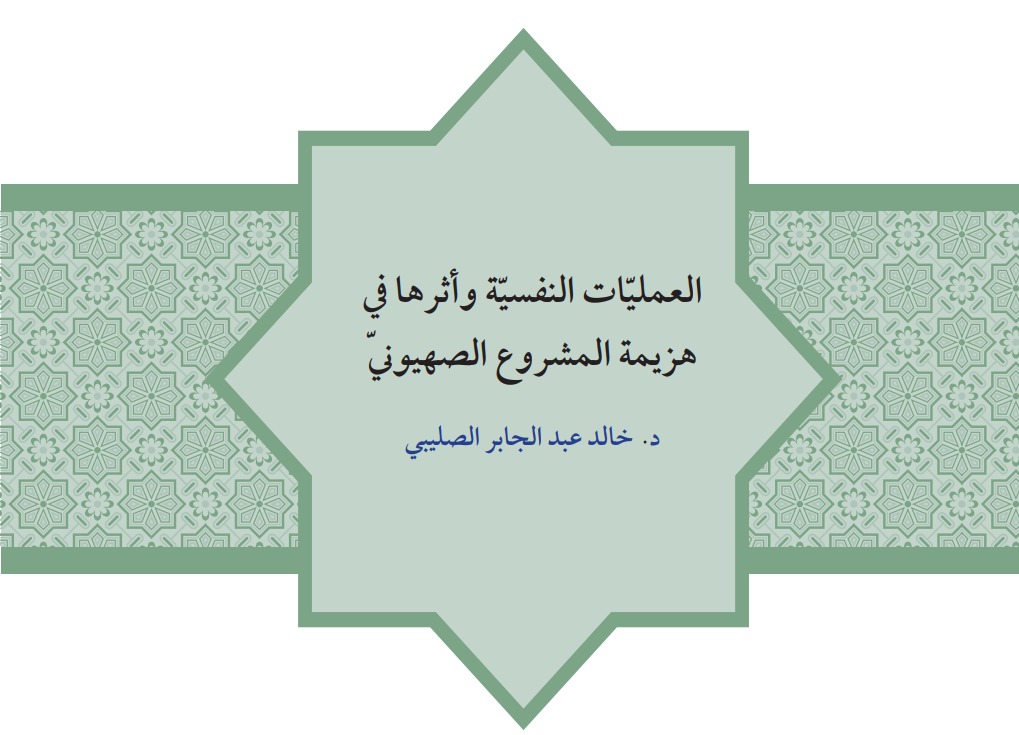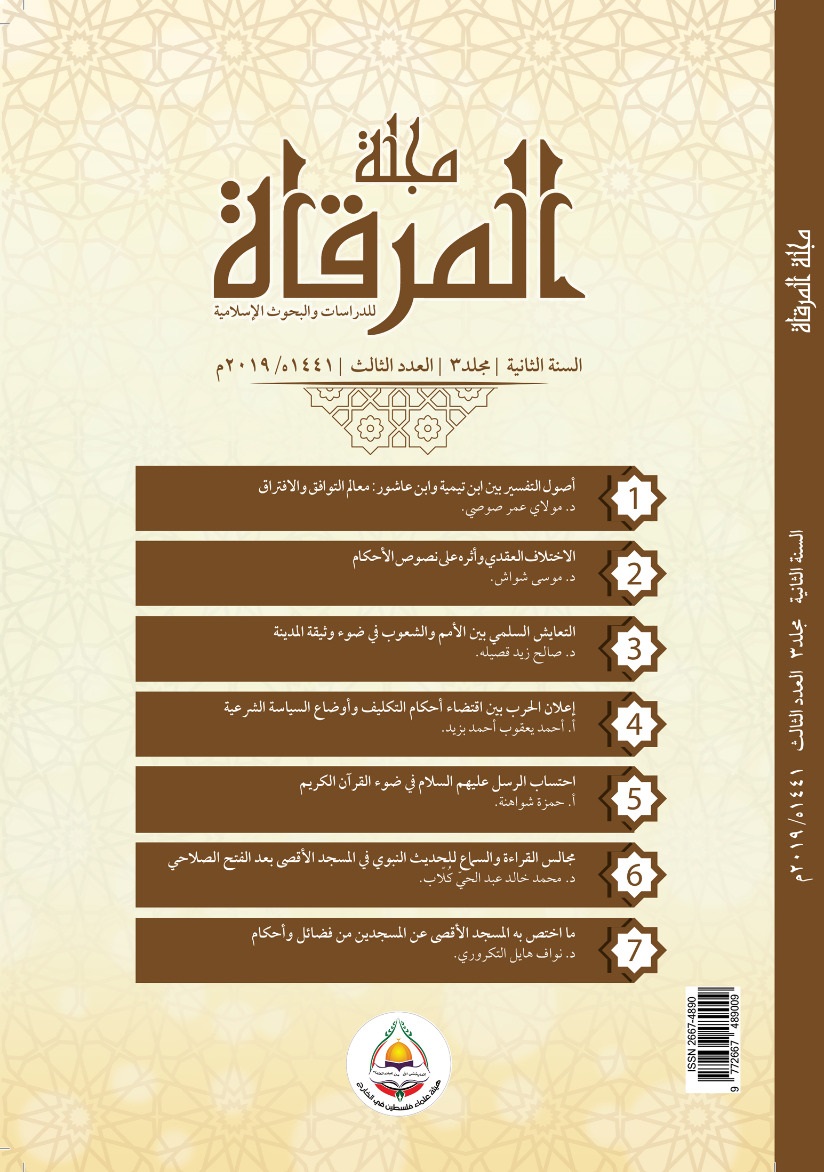خاص هيئة علماء فلسطين
“مقاربة فقهيّة تأصيليّة”
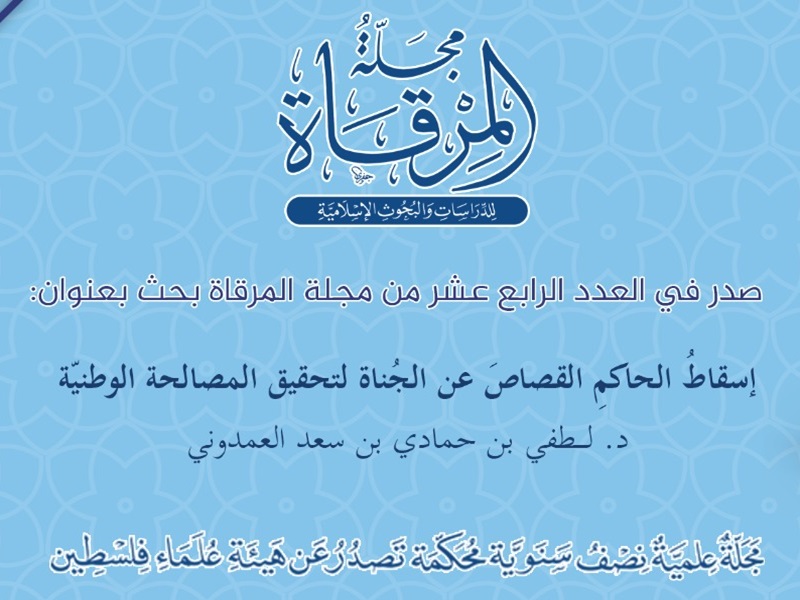
د. لـــــــــــطفي بن حمادي بن سعد العمدوني
جامعة الزيتونة – تــــــــــــــونس
الملخص:
يتناول هذا البحث بالدراسة “إسقاطُ الحاكمِ القصاصَ عن الجُناة لتحقيق المصالحة الوطنيّة” ضمن مقاربة فقهيّة تأصيلية تتجاوز عموم النّظر الفقهيّ للقصاص في عدالة تقليديّة جنائية بوصفه حقّا حصريّا لوليّ الدّم، إلى فقه السّياسة الشّرعيّة، ومعالجاتها للفتن والصّراعات الداخلية المسلّحة التي تنشأ بين الإخوة الفرقاء في الوطن، والاستلهام من التوجيه القرآني بالإصلاح بين الفئتين المقتتلتين بالعدل والقسط، وردّ البغاة بالزجر أو بالصلح، ومن معالجات الصّحابة والفقهاء لحادثة قتل عبيد الله بن عمر لنفر على خلفية اغتيال رأس الدولة الإسلامية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولمعالجتهم لحادثة اغتيال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهم أجمعين، والتفريق بين حكم إسقاط القصاص في الدماء في الجريمة التقليدية، وبين إسقاطه في الجرائم السياسية، أو النزاعات المسلحة والفتن، بمقصد المصالحة وحقن الدماء وتحقيق السلم الأهلي.
الكلمات المفتاحية: إسقاط القصاص، أولياء الدّم، المصالحة السياسيّة، جريمة البغي، ضمان إتلاف الأنفس
The Ruler’s Dropping of Retribution from Criminals to Achieve National Reconciliation: A Jurisprudential and Fundamental Approach
Abstract:
This research studies “The Ruler’s Dropping of Retribution from Criminals to Achieve National Reconciliation” within a jurisprudential and fundamental approach that goes beyond the general jurisprudential view of retribution in traditional criminal justice as an exclusive right of the blood guardian، to the jurisprudence of Islamic politics، and its treatments of internal armed strife and conflicts that arise between discordant brothers in the homeland. And drawing inspiration from the Qur’anic guidance to reform between the two warring factions with justice and equity، and to repel the rebels with deterrence or reconciliation، and from the companions’ and jurists’ treatments of the incident of Ubaidullah bin Umar killing a group of people against the backdrop of the assassination of the head of the Islamic state، the Commander of the Faithful، Umar bin Al-Khattab، and their treatment of the incident of the assassination of the Commander of the Faithful، Uthman، may God be pleased with them all. And the difference between the ruling of dropping retaliation for blood in traditional crimes، and dropping it in political crimes، or armed conflicts and seditions. With the aim of reconciliation، stopping the bloodshed and achieving civil peace.
Keywords: Dropping retaliation / blood relatives / political reconciliation / crime of oppression، guaranteeing the destruction of lives
مقدمة
مثّلت المصالحة الوطنيّة مطلبا ومدخلا أساسيّا للخروج من الأزمات التي تعصف بعافية الوطن ووحدته ومُقدّراته، ويحتاج تحقيقها إلى معالجات دقيقة لملفّات الدّماء والمظالم والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحرّيات، ولإصلاحات سياسيّة وتشريعيّة واقتصاديّة وثقافيّة…
إنّ تسوية ملف الدّماء، في سياق المصالحات الوطنيّة، مهمةٌ شاقّة جدّا ومعقّدةٌ جدّا، وهي من أثقل الملفّات نظراً إلى حجم مربّعات الفتنة والصراعات في خريطة الوطن العربي والاسلامي، وبالنظر إلى ما فيها من أرقام ومعطيات صادمة عن الاغتيالات والإعدامات، وعن قتلى المواجهات والمداهمات، إنها ملفّات الوجيعة التي لا تسكن همزاتها.
إنّ عفو الحاكم في القصاص عن الجناة، في سياق تحقيق المصالحة الوطنيّة الشاملة، من الأمور اليسيرة في الحالات التي تتوافق إرادته مع إرادة أولياء الدّم بالعفو عن القاتل أو القتلة، لكنّه يطرح تحدّيات وصعوبة كبيرة عند تعارض الإرادتين، مع اشتهار أقوال الفقهاء بأنّ عفو وليّ الدّم في القصاص حقٌّ أصليّ وحصريّ له دون سواه، حيث أوجب الشّارع القود في قتل العمد وجعل الخيار لأولياء الدم بين التمسك بإنزال العقوبة، أو العفو فقال تعالى﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ﴾ (البقرة/178)، وذلك حق أصيل لولي الدم دون غيره، ويسقط القصاص إن كان الجاني أبا للقتيل، أو كان حدثا، أو مجنونا أو أكره على القتل، ويدرأ الحد لشبهة “والقاعدة أنّ الدية تحلّ محل القصاص إذا امتنع لسبب من الأسباب الشرعيّة “[1]
لقد جعل الشارع الحكيم مقامَ أولياء الدّم مقامَ عزّ وقوّة وتمكين من رقبة المعتدي وفي ذلك شفاء لما في الصدور من الغيض والحقد على القاتل، وإطفاء لنار الثأر، وبالتحريض الإلهي على العفو فتح الباب لضمّ عزّ العفو والصّفح الى عزّ التمكين، ونص الشارع على النهي عن الانتقام والتشفي أو الافتئات أو الزيادة في العقوبة على الحد المنصوص عليه شرعا كما ندب الشارع ولي الدم الى الرحمة وقبول الديّة إذا بذلها الجاني فقال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (البقرة/178).
إنّ جعل حق اسقاط القصاص على الجناة في القتل حقا حصريا لأولياء الدم يجعل صلاحيّات الحاكم بالعفو فيه محدودة جدّا وتحتاج قراءة تأصيليّة تعتصم بترجيح ثمار المصالحة الوطنيّة على الأمّة والدّولة، والنّظر في التراث الفقهي الاسلامي المرتبط بمراحل مشابهة نظر تدقيق واستقراء.
المطلب الأول: تحقيق الصّلح والمصالحة في الفقه الإسلاميّ
1- المصالحة وسيلة إصلاح تلتقي مع مقاصد الشرع: لقد شرع الله الصّلح وسمّاه خيرا قال تعالى: ﴿والصّلح خير﴾ (النساء/128) وسماه سلما فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ (البقرة/208)، وسماه فتحا كما في قول ابن مسعود: “إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية” ومن المصالحات المشتهرة في الإسلام صلح الحديبية، وكان عمر رضي الله عنه يردّ الخصوم الى الصّلح والتّراضي بينهما على اتّفاق يعقدانه قبل فصل القضاء ويفعل ذلك بمحضر الصّحابة ولم ينكر عليه أحد ذلك وكان يقول: ردّوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإنّ فصل القضاء يورث الضّغائن”[2]. قال ابن عاشور: “للإمام والقاضي أن يجبر على الصّلح إذا خشي الفتنة ورأى بوارقها، وذلك بعد أن تُبيَّن لكلتا الطائفتين شبهتها إن كانت لها شبهة وَتُزال بالحجة الواضحة والبراهين القاطعة ومن يَأْب منهما فهو أعق وأظلم”[3]، ومن ضوابط الصّلح أنه “لا صلح إلا حيث تكون المصلحة ظاهرة وحقيقية وأنّ الصّلح جائز إلا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا” وأنّ (سِلْم المؤمنين واحدة)[4]
2- عقود المصالحة والصّلح ماضية في كلّ المعاملات: وقد أجمع المسلمون على جواز العمل بالصّلح[5] واتّفقت المذاهب الأربعة على أن الصّلح عبارة عن معاقدة يرتفع بها النّزاع بين الخصوم، ويُتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين[6]. وزاد المالكيّة على هذا بإدخال الصّلح على ما هو متوقّع من النّزاع (النّزاعات المحتملة أو الافتراضيّة) فعرفوه بأنّه: ” انتقال عن حقّ أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه”[7] أي أنّه يكون للتوقّي من نزاع متوقّع، وليس فقط لرفع ما هو قائم منها.
ونظام الصّلح والمصالحات هو نظام إسلاميّ يتمُّ خارج منظومة القضاء، وهو معمول به، منذ القدم في كثير من دول العالم إلى الآن، ويسمّى نظام الصّلح أو التّحكيم باعتماد خبراء أو من يرضاه المتخاصمان من أهل الثّقة أو الحلّ والعقد، وأكثر ما يكون في الديّات وخصومات الأموال، ومع البغاة الخارجين عن السّلطان من المعارضة المسلّحة حيث أمر القرآن بالصّلح قبل القتال، وفيه، ولو بالاستجابة لبعض المطالب أو برفع مظلمتهم وفض النزاعات مع الحركات الانفصالية أو الدينيّة وما شابهها كما سيأتي بيانه لاحقا.
3- الصّلح مطلوب في كل ما ينفع فيه الصّلح ومجالاته: وقد أمر الله تعالى بالصّلح وإصلاح ذات البين في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وفي مجالات مختلفة كالصّلح في الأموال والديات والجروح ومع الفئة الباغية التي خرجت على الحاكم ومع أعداء الدولة الخارجيين ولو كانوا كفارا…. ومنها:
– قال تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات/9)
– وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ سورة (الحجرات/9(
– وقال تعالى: ﴿فاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ سورة (الأنفال/1 (
– قال تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة/224)
– وقال تعالى: ﴿لاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء/114)
والأحاديث في ذلك كثيرة منها:
– قول رسول الله ﷺ: (أَلَا أَدُلُّكُم على أَفْضَلَ من درجةِ الصلاةِ والصيامِ والصدقةِ؟ قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ قال إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ فإنَّ فسادَ ذاتِ البَيْنِ هي الحالِقَةُ لا أقولُ: إنها تَحْلِقُ الشَّعْرَ ولكن تَحْلِقُ الدِّينَ)[8]
– وقوله ﷺ: (الصّلح جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ، إلَّا صُلْحًا حرَّم حلالًا، أو أحَلَّ حرامًا)[9]
المطلب الثاني: إسقاط القصاص حق جميع الورثة ويسقط بعفو الواحد منهم
اتجه رأي جمهور الفقهاء للقول بإسقاط القصاص إذا عفا عن الجاني ولو واحد من أولياء الدّم، أي أحد ورثته من النّساء أو الرجال على حدّ السواء، أي أن أولياء الدم الذين لهم الحق في القصاص أو التنازل عنه بالدية أو بدونها هم ورثة القتيل رجالهم ونساؤهم، وقد بوب على هذا أبو داود في سننه فقال: باب عفو النساء عن الدم[10]، وخالف غيرهم فجعله في العصبات من الذكور، “قال ابن رشد: ومن لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم، والذين لهم القيام بالدم، هم العصبة عند مالك، وعند غيره كل من يرث، وعمدتهم اعتبارهم الدّم بالدية”[11]، وبوب عليه ابن تيمية في المنتقى فقال: باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء[12]، وقَال ابن قدامة: “القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي، وروي معنى ذلك عن عمر وطاووس والشعبي… [13].
المطلب الثالث: الزيادة في الديات وتسليط أهل الشّفاعة للعفو في القصاص.
القول بإباحة الزيادة على الدية هو المشهور من أقوال الفقهاء، بل نقل فيه عدم الخلاف: “إن أبى أهل القتيل العمد، وتم تخريج الزيادة على أنها من الصلح الجائز وليس زيادة في الدية المحددة شرعا بمائة من الإبل”[14]، وتلك عناية زائدة بتحقيق الرضى وسكون الأنفس، وانطفاء نار الثأر وأحقاد العداوة بعزّ التمكين لأولياء الدم من رقبة القاتل وسلطان العفو، وعزّ الاسترضاء، قـال وهبـة الزحيلي: “ويجوز الصلح باتفـاق المذاهب الأربعة عن القصـاص في النفـس وما دون النفـس من الأعضـاء”[15] وقال أيضا: “يجـوز الصلح على القصـاص باتفاق الفقهاء، ويسـقط به القصاص، سواء أكان الصلح بأكثر من الدية أم بمثلها أم بأقل منها، وسواء أكان حالا أم مؤجلا”[16]
وقد روى ابن حبان في صحيحه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث أبا جَهمِ بنَ حُذيفةَ مصدِّقًا فلاجَّه رجُلٌ في صدقتِه فضرَبه أبو جَهمٍ فشجَّه فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا: القَوَدُ يا رسولَ اللهِ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لكم كذا وكذا) فلم يرضَوْا فقال: (لكم كذا وكذا) فلم يرضَوْا فقال: (لكم كذا وكذا) فرَضُوا وقال: (أرضيتم؟) قالوا: نَعم[17].
قال الخطيب الشربيني: “بصحة الصلح ولو كان على أكثر من الدية، وهذا قول جمهور الفقهاء، فهو مذهب الحنفية والمالكية، والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة”[18]، قال أبو عبد الله الحطاب: “يصحّ الصلح في دم العمد بمال يزيد على قدر الدية أو ينقص عنها”[19]، قال ابن قدامة: “من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية، وبقدرها، وأقلّ منها، لا أعلم فيه خلافا”[20]. وأورد السرخسي: أن الصحابة رضي الله عنهم فدوا فارسا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل قصاصا عرفوا ذلك في وجهه الشريف ففدوه بديتين[21]. وقال عبد القادر عودة: “لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلـح عـلى القصـاص، وأن القصاص يسـقط بالصلـح، ويصح أن يكون الصلح عن القصاص بأكثر من الدية وبقدرها، وبأقل منها”[22]
ومن الآليات المعتمدة، تسليط أهل الشفاعة للتحريض على الصلح بجبر الضرر والعفو في القصاص، حيث إنّ المال المبذول ليس وحده المغري بالعفو دائما، ولا بدّ من تدخل أهل الشرف والقدر الرفيع بالشفاعة، فقد جاء في البخاري: “أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ”[23].
المطلب الرابع: إسقاط القصاص عن البغاة في الفقه الإسلاميّ
يتّسم النّظر الفقهي للمصالحة مع البغاة، (المجرمين السياسيّين) بخصوصيةِ منبعها النص القرآني المرجعي الذي حددّ موجّهات مهمة في التّسويات فقال تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات/9-10).
1- العلاقة بين جريمة ” البغي” والجريمة السياسيّة، موضوع المصالحة السياسيّة
لا يبعد تعريف جريمة البغي والبغاة عن التعريف المعاصر للجريمة السياسيّة، إذ قسّم الدكتور عبد القادر عودة الجريمة إلى نوعين: عادية وسياسيّة، وقال أنّ “اختلاف الباعث هو الفيصل بين الجريمة السياسيّة والجريمة العاديّة ” فالجريمة السياسيّة ترتكب لتحقيق أغراض سياسية” [24] وأشار إلى تسمية الفقهاء القدامى للجريمة السياسيّة بمصطلح ” البغي”، وهي “الجريمة التي يكون الباعث الوحيد منها محاولة تغيير النظام السياسيّ أو تعديله أو قلبه، وتوجد الجريمة السياسيّة في حالة الثورة، وفي حالة الحرب الأهلية، فإذا ثار فريق من الرعية على الدولة، وإذا قامت حرب بين الدولة وبين بعض رعاياها الخارجين عليها أمكن أن توجد الجريمة السياسيّة إذا توافرت شروط معينة”[25]، واهتم الفقهاء بتدقيق تعريف البغاة فقال الحنابلة: “هم قوم من أهل الحقّ يخرجون من قبضة الإمامولو غير عدل، ويرون خلعه بتأويل سائغ، ولهم شوكة وفيهم منعة، ويحتاج من في كفهم إلى جميع الجيش: [26]، وفي نهاية المحتاج للرملي الشّافعي: ” هم مسلّحون مخالفون للإمام بالخروج عليه، وترك الانقياد له أو منع حق الله أو الآدمي توجب عليهم بشروط أن تكون لكم شوكة ويستندون إلى تأويل سائغ وفهم مطاع”[27]، وعند المالكية البغي ” الامتناع عن طاعة الإمام من تثبت إمامته في غير معصية بمغالبته ولو تأويلا”[28].
2- إسقاط القصاص في الدّماء، في المصالحة السياسيّة وفق أحكام جريمة البغي
لم تحدد الآيات القرآنية جهة العدوان في الفئتين، ولم تستبعد أن يكون الحاكم ظالما متعدّيا مسؤولا عن انتهاكات جسيمة، كما لا يمتنع أيضا أن يكون العدوان بالظلم من الطّائفتين، لكن نصّ الشّارع على ردّ المعتدي حتى يفيء الى أمر الله، والأمر بالإصلاح بين الفئتين بالعدل والقسط، وأهم ما في أحكام البغي مخالفة الأصل في لزوم القصاص أو الدية على القاتل، وإسقاط الضمان في الانفس والأموال، وفق رأي الجمهور مما يعدّ تعزيزا لفرص الصلح والكف عن الصراعات التي تفتك بقوة الامة ووحدتها، وتجد المصالحات الوطنية في البيئات الإسلامية والصراعات بين المؤمنين، سندا قويا من النص في الإصلاح بين السلطة والمعارضة وطي صفحة المظالم وتحقيق العدالة وكشف الحقيقة، لانّ ذلك من العدل والقسط المأمور به شرعا.
وهل في ما يقع من القتلى اثناء المواجهة بينهما قصاص أم تسقط بالمصالحة والإصلاح بين طرفي النزاع- الدولة والمعارضة المسلحة قولان:
القول الأول: يسقط ضمان الأنفس والأموال التي أتلفها أهل البغي (المعارضون السياسيّون) إلا مالًا يوجد بعينه فيرد إلى صاحبه، وهو رأي جمهور العلماء المالكية [29]والشافعية[30] في الجديد من قولهم وهو الأصح، والحنابلة[31] والحنفية[32]، قال ابن قدامة “وليس على أهل البغي أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه… “[33]
وقال السرخسي: “وإذا تاب أهل البغي ودخلوا إلى أهل العدل لم يؤخذوا بشيء مما أصابوا يعني بضمان ما أتلفوا من النفوس والأموال”[34]
وأورد ابن قدامة في المغني، والكاساني في البدائع عن الزهري أنه قال: “وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاتفقوا أن كل دم استحل بتأويل القرآن فهو موضوع وكل مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، قال الكاساني: “ومثله لا يكذب، أي الزهري، فانعقد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأنه حجة قاطعة”[35]، كما اشترطوا أن يكون ما يسقط من ضمان للأنفس والأموال في وقت القتال والمواجهات، بخلاف ما وقع قبل ذلك أو بعده، قال القرطبي: “ما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارها، فما جنته، أي الطائفة المعتدية – ضمنته عند الجميع”[36]
القول الثاني: يسقط ضمان الأموال دون الأنفس التي أتلفها أهل البغي: وهو للشافعي في القديم، وبعض الشافعية[37]، وفرّق ابن حزم[38] بين من يقبل تأويله أو كان يخفى على كثير من أهل العلم فلا ضمان عليهم في الانفس، وتدفع الدية من بيت المال، ويضمنون الأموال، بينما لا يسقط ضمان الانفس والأموال على من كان تأويله فاسدا ويجب القصاص أو الدية كما يجب تعويض الضرر في الجروح والمتلفات من الأموال[39]
الترجيـــــــــــــــــــــــــــــــح: يترجح لدينا القول الأول بعدم ضمان الأنفس والأموال تغليبا لرأي الجمهور من مختلف المذاهب الفقهية، وتغليبا للمقاصد العظيمة التي تتحقق بالعفو وبتسكين نار الانتقام والفتن والصراعات، كما يتعزز هذا الترجيح، إذا كان اجتهادا للحاكم، وهو موضوع بحثنا هذا، جريا على قاعدة ” حكم الحاكم يرفع الخلاف” المعتمدة في الفقه الإسلامي والسّارية على ألسنة العلماء، والتي سيأتي بيانها.
المبحث الخامس: إسقاط الحاكم القصاص عن الجناة لأجل المصلحة ولدرء الفتنة
شرع الله سبحانه وتعالى القصاص لحفظ الأنفس وزجر المعتدين وتعظيم الحق في الحياة فقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة/179)، وهو، كما مرَّ بيانه حق أصيل لولي الدم إن شاء لزم القصاص، وإن شاء عفا بلا دية، أو صالح على دية، ويطرح بين يدي هذا البحث، التساؤل الآتي: هل يجوز للحاكم إسقاط القصاص لتحقيق المصالحة الوطنيّة وإخماد نار الفتن كمقصد من أعظم مقاصد العدالة الانتقالية دونما الرجوع إلى ولي الدم؟ هل يحقق ذلك مصلحة معتبرة، أو يدرأ مفسدة محققة؟ وهل يكفي أن يدفع الحاكم، في مثل هكذا أوضاع، الدية لوليّ الدم؟ وهل للمسألة سوابق تاريخية؟
يمكن مناقشة هذه المسألة ورصد أقوال الفقهاء من خلال تقديم شاهدين تاريخيين مهمين حصلا زمن الخلافة الراشدة، وكانا محلّ جدل ونقاش فقهي لم يتوقف، ارتبط الأول بقصة مقتل عمر بن الخطاب، والثاني بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين.
إسقاط القصاص عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما بقتله مُسلِمَيْنِ وذِمِّيّ.
1- السياق السياسي للأحداث: ارتبطت الحادثة[40]، بحيثيات مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قتل عبيد الله بن عمر ثلاثة نفر اعتقد أنهم كانوا وراء قتل أبيه وهم: الْهُرْمُزَانُ وهو مسلم، [41]وجُفَيْنَةُ النصرانيّ وهو ذميّ[42]وجارية صغيرة مسلمة هي ابنة أبي لؤلؤة، وسنورد القصة كما أوردها ابن سعد في الطبقات موردا قصته في قتل ثلاثتهم: (… فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ دَعَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي فَتَقَ فِي الدِّينِ مَا فَتَقَ، فَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يُشَايِعُونَ عُثْمَانَ عَلَى قَتْلِهِ، وَجُلُّ النَّاسِ الْأَعْظَمُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ لَجُفَيْنَةُ وَالْهُرْمُزَانُ: أَبْعَدَهُمَا اللَّهُ، لَعَلَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُتْبِعُوا عُمَرَ ابْنَهُ؟ فَكَثُرَ فِي ذَلِكَ اللَّغَطُ وَالِاخْتِلَافُ، ثُمَّ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى النَّاسِ سُلْطَانٌ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ خُطْبَةِ عَمْرٍو وَانْتَهَى إِلَيْهِ عُثْمَانُ وَوُدِيَ الرَّجُلَانِ وَالْجَارِيَةُ)” [43] وفي رواية الصنعاني مثل ما ذكر ابن سعد وفي آخرها: “فلما ولي عثمان قال: أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق – يعني عبيد الله بن عمر – فأشار عليه المهاجرون أن يقتله، وقال جماعة من الناس: أقتل عمر أمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم؟ أبعد الله الهرمزان وجفينة قال: فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان، إنّما كان هذا الأمر ولا سلطان لك، فاصفح عنه يا أمير المؤمنين قال: فتفرق الناس على خطبة عمرو، ووَدَى عثمان الرجلين والجارية”. [44]
2- تفاصيل مهمة بين يدي حادثة إسقاط عثمان رضي الله عنه القصاص
اتفاق الرواة على أنّ عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان وجُفَينة النصراني والجارية ابنة أبي لؤلؤة دونما بيّنة على تورّطهم في قتل أبيه، إلّا من كلام سمعه من عبد الرحمان بن أبي بكر رضي الله عنهما
– استعظام جميع الصحابة ما أتاه عبيد الله بن عمر من العدوان، ولم يقرّه أحد على فعلته، “قال عثمان: أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق – يعني عبيد الله بن عمر”[45]، وفي رواية الذهبي قال”…. رأيت عبيد الله يومئذ وإنه ليناصي عثمان، وعثمان يقول: ” قاتلك الله، قتلت رجلا يصلّي وصبية صغيرة وآخر له ذمّة، ما في الحق تركك”[46]
– اختلاف الصحابة في حكم عبيد الله بن عمر إلى فريقين: فريق من المهاجرين أشار على عثمان بالقصاص وقتل عبيد الله ابن عمر، وفريق أغلبه من الأنصار استعظم مصيبة أن يقتل الابن اليوم، وقد قتل أبوه عمر رضي الله عنهما قبلا.
– تشكّل رأي غالبٌ من الصحابة وأهل المدينة لا يرضى بالقصاص[47]“وَجُلُّ النَّاسِ الْأَعْظَمُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ لَجُفَيْنَةُ وَالْهُرْمُزَانُ: أَبْعَدَهُمَا اللَّهُ[48].
– لقد أثبت المؤرخون استشارة عثمان الصحابة فاختلف الناس، فخطب عمرو بن العاص، فقال: يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان، إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك، فاصفح عنه يا أمير المؤمنين قال: فتفرق الناس على خطبة عمرو، وودى عثمان الرّجلين والجارية”. [49]
– رفع عثمان بن عفان، رضي الله عنه، الخلاف بين الصحابة باعتباره الحاكم بل ودى ثلاثتهم، جريا على قاعدة: “حكم الحاكم يرفع الخلاف” ” قال السيوطي ” حكم الحاكم إلزامٌ يرفعُ الخلاف” وعبر عنها الأصوليون والفقهاء بعبارات متقاربة، فقال ابن تيمية: “فلما استشار عثمان الناس في قتله، أشار عليه طائفة من الصحابة أن لا تقتله، فإن أباه قُتل بالأمس ويُقتل هو اليوم، فيكون في هذا فساد في الإسلام”[50]، وقال ابن القيم مثله[51]، وقد ذكر ابن تيمية كلّ التخريجات الفقهية التي حملت اسقاط عثمان القصاص عن عبيد الله بن عمر على التأوّل بأنه فعَله لوجود شبهة درأ بها الحد، أو لعدم الولي فناب الامام عنه بالعفو، أو الزّعم بعفو ابن الهرمزان…. ثم قال: “وبكل حال فكانت مسألة اجتهادية، وإذا كانت مسألة اجتهادية، وقد رأى طائفة كثيرة من الصحابة أن لا يُقتل، ورأى آخرون أن يُقتل، لم يُنكر على عثمان ما فعله باجتهاده، ولا على عليّ ما قاله باجتهاده. [52] وقال ابن كثير “والامام يرى الأصلح في ذلك، وخلّى سبيل عبيد الله”[53]. وعلّلوا ترجيحه بمقصد درء الفتنة والخوف من الفرقة [54].
3- إسقاط القصاص عن قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه درء للفتنة
مثّل مقتل خليفة المسلمين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في الفتنة، زلزالا سياسيّا بوصفه اغتيالا يستهدف رأس الدولة، في زمن حسّاس، بعد أن تمالأ عليه جماعة لعزله عن الخلافة،، وكان مقتله في 18 من ذي الحجة 35هـ، وذكرت كتب التاريخ [55] الحادثة بتفصيلاتها وبتعدّد رواتها، ونصت على أسماء القتلة وأشهر من باشر ذلك بسيفه أو خنجره، طعنا وذبحا وكانت أولى القضايا المرفوعة لنظر الإمام علي كرم الله وجهه أخذَ القصاص من قتلته إثر مبايعته بالخلافة، لكنّ عليّا ترك ملاحقة قتلته، ولا أرسل في طلبهم لمنعتهم في عصبتهم، وكثرة الهرج والفتنة والنزاع في الأحقّ بالإمامة، وقد عدّ من بايعه بالخلافة من عامّة الناس، ومن جموع الصّحابة، القصاصَ من قتلة عثمان من أوكد شروطهم في بيعتهم وأوّل تعهّداته.. لكنه تأخّر عن ذلك وأبطأ حتى شقّ عليهم.
أ- الإمام عليّ يترك طلب القصاص درءًا لفتنةِ ثائرةِ من ثاروا، وقد فعل ذلك رغم ضغوط من بايعه من الصحابة، قال الطبري: “واجتمع إِلَى عليٍّ بعد مَا دخل طَلْحَةُ وَالزُّبَيْر فِي عدة من الصّحابة، فَقَالُوا: يَا علي، إنا قَدِ اشترطنا إقامة الحدود، وإن هَؤُلاءِ القوم قَدِ اشتركوا فِي دم هَذَا الرّجل وأحلّوا بأنفسهم، فَقَالَ لَهُمْ: يَا إخوتاه، إني لست أجهل مَا تعلمون، ولكنى كيف أصنع بقوم يملكوننا وَلا نملكهم! ها هم هَؤُلاءِ قَدْ ثارت معهم عبدانكم، وثابت إِلَيْهِم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم مَا شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة عَلَى شَيْء ممّا تريدون؟ قَالُوا لا، قَالَ فلا وَاللَّهِ لا أَرَى إلا رأيا ترونه إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إن هَذَا الأمر أمر جاهلية، ولكن حَتَّى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق، فاهدؤوا عني وانظروا ماذا يأتيكم، ثُمَّ عودوا”[56].
ب- فشل حملة بقيادة بعض الصحابة في القصاص لعثمان، بعد أن قتلوا 599 نفسا ولمّا يقتلوه
لم يفلح طلحة والزبير وعائشة في القصاص من القتلة رغم محاولتهم ذلك بالبصرة، حيث تمالأ عليهم آلاف الناس، وحشدوا لقتالهما، وهو ما عبّر عنه القعقاع بن عمرو، رسول علي كرم الله وجهه في وساطته لمنع القتال مع طلحة والزبير وعائشة ممن رفعوا لواء القصاص من قتلة عثمان مؤاخذين عليّا بتخاذله في ذلك فقال مخاطبا لهما بحضرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ” قَدْ قَتَلْتُمَا قَتَلَةَ عُثْمَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَأَنْتُمْ قَبْلَ قَتْلِهِمْ أَقْرَبُ إِلَى الاستقامة منكم اليوم، قتلتم ستمائة إِلا رَجُلا، فَغَضِبَ لَهُمْ سِتَّةُ آلافٍ، وَاعْتَزَلُوكُمْ وَخَرَجُوا مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، وَطَلَبْتُمْ ذَلِكَ الَّذِي أَفْلَتَ- يَعْنِي حُرْقُوصَ بْنَ زُهَيْرٍ– فَمَنَعَهُ سِتَّةُ آلافٍ وَهُمْ عَلَى رَجُلٍ، فَإِنْ تَرَكْتُمُوهُ كُنْتُمْ تَارِكِينَ لِمَا تَقُولُونَ، وَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ وَالَّذِينَ اعْتَزَلُوكُمْ فَأُدِيلُوا عَلَيْكُمْ فَالَّذِي حَذَرَتْمُ وَقَرَّبْتُمْ بِهِ هَذَا الأَمْرَ أَعْظَمُ مِمَّا أَرَاكُمْ تَكْرَهُونَ، وَأَنْتُمْ أَحْمَيْتُمْ مُضَرَ وَرَبِيعَةَ مِنْ هَذِهِ الْبِلادِ، فَاجْتَمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ وَخِذْلانِكُمْ نُصْرَةً لِهَؤُلاءِ كَمَا اجْتَمَعَ هَؤُلاءِ لأَهْلِ هَذَا الْحَدَثِ الْعَظِيمِ وَالذَّنْبِ الْكَبِيرِ فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: فَتَقُولُ أَنْتَ مَاذَا؟ قَالَ: أَقُولُ هَذَا الأَمْرُ دَوَاؤُهُ التَّسْكِينُ، وَإِذَا سَكَنَ اخْتَلَجُوا…. فَإِنَّ هَذَا الأَمْرَ الَّذِي حَدَثَ أَمْرٌ لَيْسَ يُقَدَّرُ، وَلَيْسَ كَالأُمُورِ، وَلا كَقَتْلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَلا النَّفَرِ الرَّجُلَ، وَلا الْقَبِيلَةِ الرجل، فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذًا قَدْ أَحْسَنْتَ وَأَصَبْتَ الْمَقَالَةَ”[57]
ج- ترك معاوية القصاص لمّا استتبّ له الأمر ولم يسع في طلب القتلة طيلة فترة حكمه التي دامت 20 سنة، سالكا مسلك علي في اجتناب إشعال ثائرة من ثاروا في مقتل عثمان من عصبتهم وحلفائهم وشركائهم[58]، وسكت الصحابة عن طلب دم عثمان بعدما رأوا، نعمة الاستقرار والوحدة، بعد فتنة الاقتتال والفرقة.
الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
مثلت هذه الورقة مقاربة فقهية لموضوع “إسقاطُ الحاكمِ القصاصَ عن الجُناة لتحقيق المصالحة الوطنيّة “، وقد انبنى البحث على استقراء آراء الفقهاء، والنظر إلى هذه القضية ضمن فقه السياسة الشرعية، وإدارة السلطة للشأن العام، وتكييف جرائم القتل زمن الصراعات المسلحة والفتن ومناطق النزاعات والاغتيالات السياسية والحروب الأهلية تكييفا مختلفا عما يحدث من جرائم القتل التي تحصل في الظروف العادية، بالنظر إلى السياقات المختلفة والارتدادات الخطيرة على وحدة الامة وقوتها ومناعتها، ويترجح لدينا القول بجواز إسقاط القصاص عن الجناة، وبعدم ضمان الأنفس والأموال في المصالحات الوطنية:
– تخريجا على قول الفقهاء في حكم البغاة، عند المصالحات، بعدم ضمان الأنفس والأموال، وهو قول الجمهور، حتى إن ابن قدامة المقدسي لم يلتف إلى المخالف في ذلك، وحكى الاجماع عليه عن الزهري، ثم علّل تغليب هذا الرأي بأنه أسرع في الصلح وأيسر فقال “ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة فلا يشرع كتضمين أهل الحرب”[59]، والاجتهاد بالعفو من هذا المسلك أوسع فسحة، في تيسير أسباب جمع الكلمة والإصلاح بين المسلمين تمثّلا بقوله تعالى ﴿والصلح خيرٌ﴾، فضلا عن أنّ القول بالقصاص في ما فات من الأنفس أو من الأموال يغري بمزيد الشقاق والخلاف.
– لقد شكّلت حادثة اغتيال عمر وعثمان زلزالا سياسيا بالنظر إلى تداعياتها، وأنّ التدابير المتخذة في آخر ما استقرّ عليه أمر الفتنة بترك القصاص يعدّ إجماعا من الصحابة بترك القصاص إذا خيفت الفتنة وكثرة الاقتتال بإيقاعه، لقد شرع الله القصاص لحفظ الأنفس، ولم يتمّ تركه إلا لتحقيق المقصد نفسه، بل إنّ إقامة القصاص مع ما آلت إليه الفتنة من تجييش ونفرة للقتال جهل بمقاصد الدين، لذلك سكت الصحابة رضوان الله عنهم عن عليّ بعد ما استبانت لهم حجته في ترك القصاص، وسكتوا عن مطالبة معاوية، بعد أن عاينوا خمود الفتنة واستقرار الأمن بتركه ملاحقة قتلة عثمان، ويؤكد صحة اجتهادهم ما نتج عن سعي الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم لقتل حُرْقُوصَ بْنَ زُهَيْرٍ بالبصرة، (أحد قتلة عثمان) فأزهقت مئات الأرواح دونه، ولمَّا يقتلوه.
– لقد رجّح عليٌّ ومعاوية رضي الله عنهما ترك القصاص درءا لمفسدة عظيمة، وأنّ مقصد القصاص بزجر الجناة وتعظيم الدماء غير متحقق في مثل هكذا أوضاع، بل إنّ إسقاط الملاحقة ضمن آلية المصالحة الشاملة أجدى وأنفع وأكثر تحقيقا لمقصد حفظ الدماء والأنفس والأموال والأعراض، وإيقاف الحروب والمواجهات.
– إن المصالحات الوطنية تقطع أسباب التنازع المؤدي الى الفشل وذهاب ريح الأمة وانكسار شوكتها بين الأمم، لا سيما في سياق استعمال القوى العظمى ورقة الطائفية والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة مبررا للتدخل الأجنبي عسكريا وسياسيا لنهب مقدرات الأمة وثرواتها، ولانتهاك سيادتها وإذلالها بين الأمم.
لقد تبين من هذا البحث، أنّ إسقاطَ الحاكمِ القصاصَ عن الجُناة لتحقيق المصالحة الوطنيّة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، ويترجح لدينا القول بجواز إسقاط القصاص عن الجناة، وبعدم ضمان الأنفس والأموال في المصالحات الوطنية لما تقدم من الحجج التي أوردناها، ويتعزز هذا الترجيح إذا تبناه الحاكم (المسقط للقصاص) جريا على قاعدة: “حكم الحاكم يرفع الخلاف” المعتمدة في الفقه الإسلامي والسارية على ألسنة العلماء، قال القرافي: “اعلم أن حكم الحاكم، في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويُرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغير فُتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء”.
لذلك، وبناء على ما تقدّم، يكون إسقاط القصاص من الحاكم اجتهادا جائزا إذا أراد به إخماد نار الاقتتال الداخلي أو حربا أهلية، أو تحقيق مصالحة شاملة تحقن به الدماء وتحفظ به الانفس والأموال والأعراض
وهذا المقصد من أجلّ وأعظم مقاصد المصالحات الوطنيّة التي حققتها في كثير من المناطق والبلدان وأحلّت الاستقرار والوحدة والأمن بعد الاقتتال والفرقة والنزاعات والإرهاب..
قائمة بالمراجع والمصادر
- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
- ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد، الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ط4، 1403 ه/1983م.
- ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن محمد، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية بيروت1412ه/1992م، ط1.
- ابن تيمية، مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني، المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية، دار ابن الجوزي 1429ه، ط1.
- ابن تيمية؛ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1406ه/1986، ط1.
- ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1408هـ /1988م، ط1.
- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، المحلى بالآثار، دار الكتب العلمية بيروت، ط1.
- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري، الطبقات الكبرى، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 1410ه/1990م، ط1.
- ابن عاشور، محمّد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع تونس، 1984م، ط1.
- ابن عساكر، أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله، تاريخ دمشق، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر، بيروت 1412ه/1992م، ط1.
- ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 1397 هـ، ط1.
- ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت1983، ط1
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، السيرة النبوية من البداية والنهاية، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع لبنان 1395 هـ/1976م، ط1.
- ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط2.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، دار الرسالة العالمية، 1430ه/2009م، ط1.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المكتبة الإسلامية استانبول 1979م، ط1.
- البهوتي، منصور ن يونس، شرح منتهى الارادات، عالم الكتب القاهرة1414هـ/1993م، ط1.
- الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1.
- الحطاب، أبو عبد الله، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط1.
- الدردير، أبو البركات احمد بن محمد بن احمد العدوي، الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل، دار الكتب المصرية، ط1.
- الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، ط1.
- الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت1404هـ/1984م، ط1.
- الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلاميّ وأدلته، دار الفكر سوريا، 1985، ط 2.
- الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق طه عبد الروؤف سعد، مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة، ط1.
- السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة بيروت1414هـ/1993م، ط1.
- الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت.، ط1
- الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، الناشر: دار التأصيل1436 ه/2015م ط1.
- الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، دار التراث بيروت 1387ه، ط1.
- عليش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر بيروت1409هـ/1989م، ط1.
- العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، دار المنهاج جدة 2000م، ط1.
- عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة1407هـ.، ط1
- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية القاهرة1384هـ، ط1.
- الكاساني، علاء الدين أبو بكر مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار المعرفة بيروت لبنان، ط1.
- الكلـوذاني، أبو الخطاب محفوظ، الهدايـة في فـروع الفقه الحنبـلي، دار الكتب العلمية، 1423ه، ط1.
*******************************
************
لتحميل العدد 14 أو أي بحث ضمنه:
——————–
لقراءة جميع الأعداد مع تفاصيل الأبحاث ضمنها:
——————-
لتحميل جميع الأعداد المنشورة من (مجلة المرقاة المحكمة) بنسخة pdf:
[1] عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة1407هـ.، ص246.
[3] ابن عاشور، محمّد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع تونس، 1984م، ط1.، تفسير الآية 9 من سورة الحجرات
[4] وهي عبارة واردة في أول إعلان دستوري في تاريخ الإسلام، في صحيفة المدينة.
[5] الكاساني، علاء الدين أبو بكر مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (دار المعرفة بيروت لبنان) ج6، ص64.
ابن قدامه، المغني، م س، ج4، ص339.
[6] ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط2، ج7، ص255.
[7] الحطاب، أبو عبد الله، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ج7، ص3.
[8] الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ح 2509، ج4، ص528
[9] رواه الترمذي في سننه، م ن، ح1352.
[10] أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، دار الرسالة العالمية، 1430ه/2009م، ط1، ج4، ص675.
[11] ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 1397 هـ، ط 1، ج7، ص206.
[12] ابن تيمية، مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني، المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية، دار ابن الجوزي 1429ه، ط1، ص677.
[13] ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت1983، ج11، ص582
[14] الكاساني، م س، ج7، ص247.
= الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد بن احمد العدوي، الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل، دار الكتب المصرية، ج4، ص239.
[15] الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلاميّ وأدلته، دار الفكر سوريا، 1985، ط 2.، ج6، ص4352.
[16] م ن، ج7، ص5695.
[17] ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1408هـ /1988م، ط1، كتاب السير، ج10، ص340، ح 4487
[18]. الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت. ج4، ص53.
[19] الكلـوذاني، أبو الخطاب محفوظ، الهدايـة في فـروع الفقه الحنبـلي، دار الكتب العلمية، 1423ه، ط1، ج1، ص196.
[20] ابن قدامة، المغني، م س، ج11، ص595.
[21] السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة بيروت1414هـ/1993م، ج21، ص10
[22] عودة، عبد القادر، م س، ج2، ص167.
[23] البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المكتبة الإسلامية استانبول 1979م، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، ج2، ح2556، ص962
[24] انظر كتابه: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، م س، ص100وما بعدها
[25] م ن، ص101.
[26] البهوتي، منصور ن يونس، شرح منتهى الارادات، عالم الكتب القاهرة1414هـ/1993م، ج4، ص114.
[27] الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت1404هـ/1984م، ج8، ص48.
[28] الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، ج4، 426. /
= الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية – القاهرةط1، 2003،، ص6.
[29] عليش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر بيروت1409هـ/1989م، ج9، 202.
[30] العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، دار المنهاج جدة 1412ه/2000م، ط1، ج12، ص 30.
[31] البهوتي، شرح منتهى الارادات، م س، ج3، ص391.
[32] السرخسي، م س، ج10، من127الى128.
[33] ابن قدامة، المغني، م س، ج8، ص118.
[34] السرخسي، م س، ج10، ص127.
[35] الكاساني، بدائع الصنائع، م س، ج8، ص209.
[36] القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية القاهرة1384هـ، ج16، 320.
[37] العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، م س، ج12، ص30 وما بعدها.
[38] ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، المحلى بالآثار، دار الكتب العلمية بيروت، ج11، 246و347.
[39] م ن.
[40] هذه الحادثة مُثبة في كتب التاريخ، وفي مصادر كثيرة: انظر في ذلك مثلا:
= الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، الناشر: دار التأصيل1436 ه/2015م ط1، كتاب المغازي، حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عنه، ج5، ح 9775، ص475.
= ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري، الطبقات الكبرى، ذكر استخلاف عمر رحمه الله، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 1410ه/1990م، ط1، مج3، ص522، ح رقم. 3828
= ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد، الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ط4، 1403 ه/1983م، ج3.
السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص47
= ابن عساكر، أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله، تاريخ دمشق، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر، بيروت 1412ه/1992م، ط1ج38، ص62
[41] قال ابن تيمية: “إن الهرمزان كان من الفرس الذين استنابهم كسرى على قتال المسلمين، فأسره المسلمون وقَدِموا به على عمر، فأظهر الإسلام، فمنَّ عليه عمر وأعتقه.
ابن تيمية؛ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1406ه/1986، ط1، ج6، من 276.
[42] جفينة النصراني هو من نصارى الحيرة أرسله سعد بن أبي وقاص إلى المدينة ليعلم أبناءها القراءة والكتابة/م ن.
[43] ابن سعد، الطبقات، م س، مج3، ص522، ح رقم. 3828
[44] الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، م س، ج5، ح 9775، ص475.
[45] م ن. ج5، ح 9775، ص475.
[46] ابن عساكر، تاريخ دمشق، م س، ج4، ص339.
[47] ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن محمد، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية بيروت1412ه/1992م، ط1، ج4، ص339.
[48] م ن.
[49] الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، م س، ج5، ح 9775، ص475.
[50] ابن تيمية، منهاج السنة، م س، ج6، من 276 الى 287.
[51] ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك، م س، ج4، ص339.
[52] ابن تيمية، منهاج السنة، م س، ج6، من 276 الى 287.
[53]ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، السيرة النبوية من البداية والنهاية، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع لبنان1395هـ/1976م، ج7، ص167.
[54] م ن، ج7، ص167.
[55] انظر في ذلك: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، دار التراث بيروت 1387ه، ط1، ج4، ص 87 الى 243. و430 وما بعدها
- ابن عساكر، تاريخ دمشق، م س، ج4.
- ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، م س، ج4
- الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، ج5، و6
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، البداية والنهاية، م س، م. ج7
- ابن تيمية، مجموع الفتاوى، م س، ج7.
[56] الطبري م س، ج4، ص437
[57] الطبري، م س، ج4، نزول أمير المؤمنين ذا قار، ص487.
[58] نظر في ذلك:
- الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، م س، ج4، ص 87 الى 243. و430 وما بعدها
- ابن عساكر، تاريخ دمشق، م س، ج4.
- ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، م س، ج4
- الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، ج5، و6
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، البداية والنهاية، م س، م. ج7
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، م س، ج7.
[59] ابن قدامة، المغني، م س، ج8، ص118